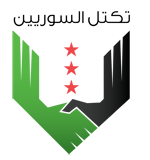حسان الأسود
سؤالٌ مطروقٌ همساً وجهراً منذُ عدّة أعوامْ منذُ أن بدأتْ تعلو أصواتُ السوريّاتِ والسورييّنَ المنادينَ بالحريّةِ والكرامةِ وصولاً إلى خروجِ الكثيرِ من المناطقِ عن قبضةِ النظامِ السوري العسكريّةِ والأمنية. مطروقٌ همساً من حاضنتهِ الشعبيّةِ وجمهورهِ وأصحابِ القرارِ في مختلفِ مفاصل النظامِ ومؤسساتِ الدولةِ من مختلفِ المستويات، وجهراً من أبناءِ الشعبِ المقيمِينَ خارجَ حدودِ سطوته، ومن قادةِ الدولِ الصديقةِ والحليفةِ لهُ قبلَ تلكَ التي ناصبتهُ العداءْ.
تعزّزَ هذا الأمرُ بعدَ أن هبّ الحلفاءُ لنجدةِ حليفهم، وباتَ التفاخرُ بالحديثِ عن إنقاذِ النظامِ في أيّامه الأخيرة قبل السقوطِ أمراً مكروراً، ولم يقتصرْ على الدولِ بل إنّ تنظيماً ميليشياويّاً مثل ” حزبُ الله ” كانَ له نصيبُ من هذا التفاخُرْ.
الحكمُ بالتعريفِ هو ممارسةُ السلطةِ السياديةِ على أراضي الدولةِ وعلى الشعبِ الذي يعيشُ على هذه الأرض، والسلطةُ هي القدرةُ على التنبّؤ واتخاذِ القرارِ وتنفيذه والتنسيقُ بين مؤسساتِ الدولةِ المختلفةِ لإدارةِ المواردِ وتأمينِ استمرارِ المجتمع، فالحكمُ هو الوسيلةُ التي تستطيعُ بها الدولةُ القيامَ بوظائفها الداخليةِ والخارجيّةِ ويجب ألّا ينافسَها في هذه الوظيفةِ أحدٌ فهي من يقومُ بالرعايةِ والإدارةِ ويحتكرُ العنفَ المُقونن وأدواتَهِ العسكريةَ والأمنية، والمقصودُ هنا أنَّ الدولةَ يجب أن تكونَ وحدَها من يمتلك سلطةَ سنّ القوانينِ وتنفيذها جبراً كأحدِ أهمِّ وظائفها لتحقيقِ مصلحةِ الناسِ الذين تخدمُهم مؤسساتُها، ويختلفُ الأمرُ عندَ الحديثِ عن الحكمِ الدكتاتوري الذي يستلبُ الدولةَ ويحيلها إلى أداةٍ لتأبيدِ نظامِ الحكم، فتلك لا تستطيعُ إنتاجَ شيء غيرَ العنف وهو بالضرورةِ لن يكونَ مقونناً بل منفلتاً من كلِ لجام .
وبالرجوعِ إلى وظيفةِ الحكمِ في سوريا نجدُها انحصرتْ تدريجيّاً منذُ عهدِ عبد الحميد السرّاج رئيس ” المكتب الثاني ” أيام الوحدةِ مع مصر- الذي قتلَ السياسةَ وأرسى قواعدَ الدولةِ الأمنيةِ المخابراتية – بمهمّةِ إنتاجِ العنفِ وتصديره، ولم تكن عملياتُ التنميةِ أو البناءِ المجتمعي إلّا عَرَضَاً من أعراضِ الحفاظِ على سلطةِ العسكرِ والحزبِ ومن ثمّ الفردِ المتألّه،
فعلى سبيلِ المثال كان الدفعُ بأبناءِ الطبقاتِ المهمّشةِ من قرى الساحلِ السوري للانتسابِ إلى الجيشِ والأجهزةِ الأمنيّة أحدَ أشكالِ إنتاجِ العنفِ واستدامته من خلالِ ربط مفهومِ البقاء لديهم بمفهوم السيطرة الدائمة على الحكم عبر استخدام القوّة والتجبّر ونفي الآخر، وهذا ما أثبتتهُ أفعالُ النظامِ الحاكمِ على مدارِ سبعةِ أعوامٍ خلتْ منذ انطلاقِ الثورةِ ضدّه، حيثُ كانت حملاتُ القتلِ والاعتقالِ والتدميرِ الممنهج والتهجيرِ القسريّ واستخدامِ السلاحِ المحرّمِ دولياً والسلاحِ عشوائي الضرر والسلاحِ الكيماوي عشراتِ المرّات بمثابةِ قيمةٍ إنتاجيّةٍ لا يتقنُ سواها.
أقامَ حافظُ الأسد حكمَهُ أساساً على مجموعةِ ركائزَ أمنيةٍ وعسكريةٍ تستلهمُ وتطبّقُ أفكارَ هتلر وستالين عن استلابِ الدولةِ والمجتمع بجميعِ الطرقِ والأشكالِ المتاحة، وفي سبيلِ إقامةِ ومن ثمّ إدامةِ هذه السيطرةِ فتحَ مجالَ التنافسِ على مصراعيه أمامَ أجهزتهِ الأمنيةِ والعسكريةِ لتتبارى في إثباتِ الولاءِ لشخصهِ كهدفٍ أوّلٍ لإنشائها وفي تعزيزِ رقابتها على بعضها البعضِ من جهةٍ ثانية، وكان الفسادُ أحدَ أهمّ الأدوات التي مكّنَ من خلالِها زبانيتَهُ من القبضِ على مفاصلِ الدولةِ والمجتمعِ والفضاءِ العامِ السياسي والاقتصادي والثقافي حتى.
توزّعتْ السُلطةُ عملياً بين الأجهزةِ الأمنيِة والعسكريةِ المربوطةِ بخيط السُبحةِ التي يقبضُ عليها حافظ الأسد، وكان من الطبيعي بين الفينةِ والأخرى أن يُعطي دروساً قاسيةً لرجالِ سُلطته كي يعرفَ كلُّ واحدٍ منهم حجمهُ الحقيقي، فكانت إقالةُ بعضِ الشخصياتِ التي تُعتبر من أعمدةِ الحكمِ لديه مثل “محمد الخولي وعلي حيدر وعلي دوبا ” أمراً أقلَّ من طبيعي، وكانت أركانُ حُكمهِ لا تهتزُّ أبداً جرّاءَ هذه الإقالاتْ لأنها مبنيةٌ أساساً على الولاء لهُ كذاتٍ جامعةٍ دونَ أن يكونَ من الممكن أن تتطوّرَ أيةُ شخصيةٍ لدرجةٍ تكون فيها قادرةً على صُنعِ فارقٍ لوحدها يُخلُّ بميزانِ القوى. من هذا المنطلق كان توافقُ مراكزِ القرارِ الداخليّةِ جميعُها عام 2000 على توريثِ الحُكمِ لبشار الأسد لعدمِ قَبولِ أيٍّ منها الخضوعَ للآخر، وهذا ما كان يعملُ عليه حافظُ الأسد طيلةَ ثلاثينَ عاماً من حُكمهِ هندسَ خلالها الدولةَ ومؤسساتها لتكون عَرَضَاً من أعراضِ الحُكم والسلطةِ لا ميداناً للخدمةِ العامّةِ للمجتمعِ والشعبْ.
بنى حافظ الأسد أجهزةَ الحكم وأعادَ تشكيلَ مؤسساتِ الدولة من خلال إيديولوجية الخوفِ و الترهيب ومن خلال استخدامِ العنف السافر، وكذلك فعلَ حلفاؤهُ في نظام الملالي الإيراني، وكان تحالفُهما قائماً على الأسسِ المشتركة التي بُنيَ عليها نظاما الحكمِ في البلدين وخاصّةً النهجَ القائمَ على القوةِ والعنف الذي هو النهجُ المعتمدُ لدى الأنظمةِ الشمولية في العالم كلّه، وعندما سيطر تنظيمُ الدولة الإسلاميّة ” داعش ” استطاعَ ملءَ فراغِ العنفِ من خلال إنتاجِ نظامٍ شبيهٍ إلى حدٍّ ما بنظام آل الأسد مع استخدام إيديولوجية الخوف بطريقةٍ مختلفة، وقد كان القاسمُ المشتركُ بين الجميع الاعتمادَ على الفئات المهمّشةِ المضطهدةِ التي يسهُل حُكمها بالحديدِ والنار للمحافظةِ على حالةِ تبعيّةِ القطيع .
كان التحوّلُ الأخطرُ الذي طرأ على مسيرةِ حكمِ آل الأسد الانعطافةَ الكبرى في نظرةِ المُجتمع الدولي لهذا النظامِ الوظيفي في المنطقةِ بعد قرارهِ الخاطئْ باغتيالِ أو على الأقلْ بالمساهمةِ أو بالسكوتِ عن اغتيالِ رئيسِ الوزراءِ اللبناني الأسبقْ رفيق الحريري. أدّى هذا الأمرُ كنتائجَ مباشرةٍ لخروجِ جيشهِ ذليلاً من لبنان ليحلَّ محلّهُ ويملأَ الفراغَ الذي تركهُ جهازُ ” حزبُ الله ” الأمني والعسكري ، مما يعني ضياعَ أحدِ أكبرِ مراكزِ القوّةِ الخارجيةِ التي كانتْ بين يديه والتي كان يديرُها بواسطةِ جهازِ المخابراتِ الذي تربّعَ على عرشهِ فترةً طويلةً اللواء غازي كنعان الذي صارَ بدورهِ فيما بعدُ أحدَ ضحايا طاحونةِ العنفِ المستعر.
جاءتْ الضربةُ الثانيةُ لبنيةِ هذا النظامِ وطريقةِ توزّعِ السلطةِ ومراكزها وبالتالي جوهرِ الحُكمْ، بعد اندلاعِ الاحتجاجات في درعا في 18-3-2011 وانتشارِها السريعِ في عُمومِ سوريا بما باتَ يُعرف باسم ” الثورةُ السورية “.
بعدَ خساراتهِ الكُبرى في المعاركِ مع الثوّارِ المسلّحين وبعد حالاتِ الانشقاقِ الكبيرةِ والاستنزافِ البشريّ الهائلِ في صفوفِ الجيشِ خاصّةً،
اضطرَّ النظامُ إلى الاستعانةِ بالمليشياتِ المحليةِ ” الشبيحةُ ” أو ما تمّت تسميتهُ لاحقاً ” الدفاعُ الوطني ” ومن ثمّ بالمليشياتِ الطائفيةِ اللبنانيةِ والعراقيةِ والأفغانيةِ والباكستانيةِ ” حزبُ الله اللبناني، عصائبُ أهل الحق، فاطميون، زينبيّون … إلخ ” وبعدها بالحرسِ الثوري الإيراني وأخيراً بالقواتِ الروسية.
أدّى هذا الأمرُ إلى تبعثرِ السُلطةِ بدلَ توزُّعها المنضبطِ سابقاً، فقد باتتْ كثيرٌ من الميليشياتِ خارجَ دائرةِ القرارِ المركزي المباشر ، لدرجةٍ أثارتْ سخطَ الحليفِ الروسي الذي لم يعدْ يأخذُ أجهزةَ النظامِ والقوّاتِ الرديفةِ ” الميليشيات ” على محملِ الجدْ ولم يعدْ يركُنُ إليها وباتَ يتسلّمُ بذاتهِ وبواسطةِ قواتِ شرطتهِ العسكريةِ المناطقَ التي يُرغمُ أهلَها والفصائلَ العسكريةَ فيها على المصالحةِ كما حصلَ في حلب والغوطة ، وباتَ انتقادُ حالاتِ التسيّبِ والفسادِ وانحلالِ السُلطةِ أمراً اعتياديّاً في الصحافةِ الروسيّةِ التي لا تنطقُ – غالباً – عن الهوى بل من وحيِ إرادةِ الكرملين، مما يعني من حيثُ النتيجة اقتطاعُ جزءٍ آخر من السلطةِ بيد الحليفِ الروسي .
ومن جهةٍ ثانيةِ تقاسمتْ الميليشياتُ الكرديّةُ في الشمالِ هذه السُلطةَ مع النظامِ في مركزِ مدينةِ الحسكة وفي بعضِ أماكنِ وجودِهم المشترك في حلب، وفقدَ النظامُ كلَّ سلطاتِه في باقي أماكنِ سيطرةِ هذه الميليشيات التي باتتْ مرجعيّتُها وصاحبُ القرارِ فيها القوّاتُ الأمريكيةُ في الرقةِ ومناطقِ شرقِ الفراتْ، هذا كلّه بالإضافةِ إلى القواعدِ العسكريةِ الخالصةِ للقواتِ الأمريكيةِ وباقي قوّاتِ التحالف الغربي.
من جهةٍ ثالثةٍ خرجتْ مناطقُ كثيرةٌ من سُلطةِ الأسد وتناوبتْ عليها سُلطاتُ الأمرِ الواقع بدءاً من قواتِ الجيشِ السوري الحر وفصائلهِ الثوريةِ المختلفةِ وانتهاءً بقواتِ ” داعش والنُصرة ” وباقي التنظيماتِ المتطرّفة.
نافستْ هذه القوى مؤسساتِ النظامِ في تقديمِ الخدماتِ للواقعينَ تحتَ سُلطاتها، وكلٌّ انطلقَ من رؤيتهِ الخاصّةِ لتوظيفِ هذا الأمرِ في استدامةِ سلطانه، فقد وُجدتْ في كلِّ المناطقِ الخاضعةِ لسيطرةِ قوّاتِ الأمرِ الواقع مؤسساتٌ أمنيةٌ وقضائيةٌ وإداريّةٌ خدميةٌ وفرتْ – رغمَ عدمَ نجاحِها في مأسسةِ عملِها بشكلٍ مُرضٍ وكافٍ لأسبابٍ ليسَ هنا مجالُ ذكرِها – احتياجات الناسِ المشمولينَ في نطاقِ السيطرةِ هذه.
بعدَ استعادةِ نظامِ الأسد السيطرةَ على الكثيرِ من المناطقِ في حلبَ وريفِ دمشقَ وريفِ حمصَ وحماة باتَ همّهُ الشاغلُ إعادةَ تجنيدِ أبناءِ هذه المناطقِ في قوّاتِ جيشهِ المتهالك، وهذا هو الشكلُ الوحيدُ الذي يستطيعُ به – بحكمِ طبيعتِه – ممارسةَ السلطةِ والسيادة، فمفهومُ الخدمة العامّة القائمةِ على مبدأ الحقوقِ التي يقابلها واجبات أي التبادلُ باتجاهين محذوفٌ من قائمةِ مصطلحاته، فالخدمةُ باتجاهٍ واحدٍ فقط من الفردِ إلى النظامِ وليسَ العكس.
يرسمُ هذا الخطُّ البيانيُ المتعرّجُ صعوداً وهبوطاً مساراتِ بسطِ النفوذِ والسيطرةِ وبالتالي الحُكمِ في سوريا، وقد مرّ هذا الخطُّ بانحناءاتٍ و تعرّجاتٍ كثيرةٍ كانت أقواها تلك التي بدأتْ في العام 2011 عندما ثبتَ أنَّ هذه السلطةَ المبنيّةَ على أيديولوجيةِ الخوفِ و التخويف وممارسةِ العنف بقدرِ ما كانت قويّةً و اعتمدتْ الدمَ و النارْ بقدرِ ما هي هشّةٌ تصدِّعُها إرادةُ الناس ، ومن المرجّحِ بشكلٍ كبيرٍ جدّاً أن تبقى هذه الفجواتُ في ضياعِ السلطةِ وتبعثُرها موجودةً لفتراتٍ طويلةٍ حتى يتبيّنَ الشكلُ النهائيُّ للخارطةِ السوريةِ التي مازالتْ تُرسمُ بقراراتِ الساسةِ ومدافعِ ودبّاباتِ العسكر.
و رغمَ العثراتِ التي مرّتْ فيها ثوراتُ الربيعِ العربي وخاصّةً الثورةُ السوريّةُ، يبقى لها الفضلُ في كشفِ هشاشةِ هذه الأنظمة و سهولةِ انهيارها رغم محاولةِ تحصينها بالقوّة و إدارةِ المصالح و تقديمِ التنازلاتِ لأي كان إلّا إلى الشعبِ الذي يجب أن يكونَ المصدرَ الحقيقيّ والوحيدَ للسلطة.